التدخل من دارفور إلى ليبيا: تأملات في المبدأ والتطبيق


في عام 1996 نشر معهد بروكينغز الأمريكي كتاباً أعده الدبلوماسي السوداني السابق والخبير القانوني الدولي الدكتور فرانسيس دينق مع مجموعة من الأكاديميين الأمريكيين بعنوان 'السيادة كمسؤولية'، جاء فيه أن مبدأ سيادة الدول يجب ألا يصبح ستاراً تتدثر به الأنظمة التي فشلت في حماية مواطنيها، وعاصماً من التدخل الدولي في شؤونها الداخلية إذا أخفقت في تحمل مسؤولياتها. وأكد دينق وشركاؤه في هذا الكتاب على أن تحمل أمانة السيادة يفرض مسؤوليات ذات شقين: الشق الأول هو مسؤولية الدولة المعنية أمام شعبها، والثاني مسؤولية الدولة أمام رصفائها من الدول الأخرى. وعليه فإن الدولة لا بد أن تتحمل المساءلة أمام شعبها إذا مارست مقتضيات السيادة بما يخالف مصالحه، وأمام رصفائها من الدول الأخرى إذا بلغ إخفاقها في تحمل مسؤولياتها حداُ لم يعد من الممكن احتماله.
لا شك أن دينق كان يستحضر الحالة السودانية وهو يسطر ما كتب، إذا أن حرب الجنوب كانت في أوجها في تلك الأيام، وكان الكثيرون من منتقدي الحكومة السودانية، ودينق من بينهم، يرون أنها ارتكبت تجاوزات فاقت حد الاحتمال، واستوجبت التدخل الأجنبي. ولكن فكرة التدخل في شؤون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تكن مستساغة وقتها، لأن ميثاق المنظمة شدد على عدم التدخل ما لم يقع تهديد للسلم الدولي. بل إن المجتمع الدولي أدان مثل هذا التدخل، كما كان الحال عندما تدخلت فيتنام عام 1979 في كمبوديا لإطاحة نظام الخمير الحمر ذي السجل الأسود في مجال الإبادة الجماعية، فلم تحصد سوى الإدانة، حتى من الدول الغربية. وعليه كان لا بد من طرح جديد يبرر مثل هذا التدخل.
لم تكن الحالة السودانية هي الوحيدة التي شجعت هذا الطرح، حيث تفجرت أزمات متلاحقة منذ بداية التسعينات، خاصة في افريقيا، جعلت قضية المسؤولية الدولية الجماعية عن أمن المدنيين في مناطق النزاع مطروحة بقوة على بساط البحث. وكانت أزمات الصومال وليبريا من أبرزها، حيث انهارت الدولة في تينك البلدين، ولم يعد للحديث عن السيادة معنى في غياب الدولة ومؤسساتها، وانتشار حالة الفوضى وتجبر الميليشيات على المدنيين العزل. وقد أدى هذا إلى عدة مستويات من التدخل لمعالجة الطوارئ الإنسانية الناتجة. ففي ليبيريا تدخلت منظمة دول غرب افريقيا عام 1990 لإقرار السلم هناك، وفي الصومال تدخلت الأمم المتحدة في عام 1991 ثم الولايات المتحدة في عام 1992. في نفس تلك الفترة انعقد في عام 1991 مؤتمر كمبالا بمبادرة من الرئيس النيجيري السابق أولوشون أوباسانجو بغرض تطوير منظمة الوحدة الافريقية باتجاه تعميق مسؤوليتها التضامنية عن الأمن والسلم والتنمية والديمقراطية لكل شعوب القارة. وبحسب وثائق وتوصيات ذلك المؤتمر فإن هذا التوجه كان يتطلب التدخل لحفظ الأمن وفض النزاعات والتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
في نفس تلك الفترة وقعت حوادث جسام في بلدان مثل رواندا وسيراليون ويوغسلافيا السابقة أحدثت صدمة دولية نسبة لحجم الفظائع والمجازر التي ارتكبت، وأيضاً لعجز المجتمع الدولي والمؤسسات الإقليمية عن التصدي لتلك الفظائع أو التأخر في ذلك. وفي عام 2001 شكلت الحكومة الكندية لجنة دولية برئاسة وزير خارجية أستراليا الأسبق غاريث إيفانز نشرت تقريراً دعا إلى إقرار مبدأ ما سمي بـ 'مسؤولية الحماية'، مطوراً بذلك فكرة 'أمانة السيادة' التي طرحها دينق ورفاقه. وبحسب هذا المبدأ فإن هناك مسؤولية أممية جماعية لحماية الفئات التي تتعرض لخطر الإبادة أو الانتهاكات الجسيمة، وأن هذه المسؤولية يجب أن يتم الاضطلاع بها في مبتدأ الأمر بالوسائل الدبلوماسية والوقائية، ولكن إذا فشلت تلك الوسائل، فإن التدخل العسكري المباشر يصبح واجباً شريطة أن يجيزه مجلس الأمن، مع وضع الاحتياطات بعدم إساءة استخدام هذا المبدأ من دول قد تكون ذات مطامع استعمارية.
لم يلق التقرير ومناشداته أذناً صاغية بادئ الأمر، لأن أحداث الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر غطت على ما عداها، ولكن الأمم المتحدة عادت لمناقشة الأمر بعد حين، وتم تبني المبدأ رسمياً في قمة عقدت في نيويورك عام 2005 (شارك فيها السودان على مستوى الرئاسة). وفي تلك الفترة كانت قضية دارفور أصبحت محور اهتمام دولي غير مسبوق، وضغوط من جهات عدة رسمية وشعبية للتدخل باسم هذا المبدأ، خاصة بعد أن صنفت الولايات المتحدة ما وقع في دارفور على أنه إبادة جماعية. وكان الكثيرون يرون أن تبني مثل هذا المبدأ لم يقع إلا للتصدي لأزمات مثل دارفور، رأى الكثيرون أن الدولة قصرت فيها في حماية المدنيين، بل ساهمت في استهدافهم. إلا أن المبدأ لم يطبق في دارفور كما تصور له من صاغوه، وذلك لعدة أسباب، أولها هو أن الدول التي كانت تتصدى عادة لمثل هذا التدخل، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، كانت في ذلك الوقت غارقة حتى أذنيها في حروب أفغانستان والعراق، إضافة إلى أن مكانتها كدول صالحة للاضطلاع بدور إنساني أصبحت موضع تساؤل بعد تدخلها السافر في العراق لأسباب لم تكن الدوافع الإنسانية من بينها. من جهة أخرى فإن نفس تلك الدول كانت حريصة على علاقتها مع الخرطوم لأنها كانت كذلك منهمكة في مفاوضات نيفاشا التي كانت تخشى أن تفشل لو أصبح التدخل في دارفور واقعاً. هناك أيضاً دلائل على أن الجهات الدولية لم تكن مقتنعة تماماً بتأكيداتها حول وقوع الإبادة الجماعية، التي تحتم بالضرورة تحركاً سريعاً ومباشراً للتصدي للكارثة.
في نفس الوقت كان الاتحاد الافريقي، الذي طور مؤسساته وفق مبادئ مؤتمر كمبالا، جاهزاً للعب دور في التصدي للأزمة، وقد بادر لذلك بالفعل. ولهذا وجدت الدول المعنية في هذا الدور عذراً ومخرجاً، حيث خولت الاتحاد الافريقي الاضطلاع بمسؤولية واجب الحماية نيابة عن المجتمع الدولي. ورغم أن قرارات اتخذت فيما بعد بتكليف الأمم المتحدة هذا الدور، إلا أن الاتحاد الافريقي ظل هو 'الوكيل المعتمد' للمجتمع الدولي فيما يتعلق بمهمة الحماية في دارفور. وجدير بالذكر أن فرانسيس دينق، مستشار أمين عام الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية (كان يتولى حينها مهمة ممثل الأمين العام لشؤون النازحين) أيد في ذلك الوقت قرار عدم التدخل لصالح الدور الافريقي، قائلاً إن التدخل سيعقد الأمور وقد يطيح باتفاقية السلام الشامل.
ما شهدته دارفور يؤكد أن التوجه العام لدى المجتمع الدولي هو الحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بالتدخل الإنساني، لأن معظم الدول تتردد كثيراً خشية التورط في حروب أهلية لا نهاية لها، خاصة حينما لا تكون لها مصلحة مباشرة في الأمر، مما يجعلها تتلمس المعاذير لتفادي التدخل. وحتى بعد قرارات الأمم المتحدة، ما تزال الدول لم توف بتعهداتها تجاه القوة الأممية الافريقية المشتركة في دارفور. وهذا يشير إلى إشكالية أخرى تواجه إنفاذ مبدأ التدخل الإنساني: الكلفة. فالتدخل العسكري مكلف جداً، حيث ظلت الولايات المتحدة على سبيل المثال تنفق أربعة مليارات دولار شهرياً في العراق، وتواجه قوات الاطلسي في أفغانستان تكاليف مقاربة. وحتى في عملية محدودة مثل قوات اليوناميد في دارفور، فإن الكلفة تبلغ أكثر من مليار ونصف المليار دولار سنوياً. وعليه فإن الدول القادرة ستختار بعناية مواقع تدخلها، لأنها ببساطة لن تتمكن من التدخل في كل مكان يتعرض فيه الناس لوطأة حكامهم.
من هنا فإن الحالة الليبية تعتبر بحق أول حالة من حالات التدخل الإنساني المشرع دولياً منذ أن تبنت الجمعية العامة المبدأ في قمة عام 2005، وهو تدخل جاء بعد التردد المعهود والخلافات بين الفرقاء. وكان المستغرب موقف الجامعة العربية غير المسبوق بالانحياز إلى الشعب ضد نظام عضو في الجامعة، وهو ما كانت كل الأنظمة ترفضه وتخشاه. فبخلاف الاتحاد الافريقي الذي طور مؤسسات ومبادئ ملزمة للأعضاء ومبررة للتدخل في شؤون دوله، ظلت الجامعة العربية نادياً للأنظمة ضد الشعوب، لم تحرك في يوم ساكناً لنصرة مواطن. وقد رأينا مصداق ذلك في الموقف من انقلاب موريتانيا في عام 2008، حيث تصدى الاتحاد الافريقي للانقلابيين وجمد عضوية موريتانيا ومارس الضغوط على المجلس العسكري، بينما وقفت الجامعة متفرجة، بل مؤيدة على استحياء.
ويبدو أن السر في موقف الجامعة هو أن القذافي لم يترك صديقاً، بحيث كان لكل دولة عضو ثأر أو مشكلة معه. وليس صدفة أن الحكومة اللبنانية، التي يغلب عليها أنصار موسى الصدر المغيب في ليبيا، كانت ممن تبنى القرار الأممي. كذلك فإن القذافي ظل يمثل أفضل دعاية لمعارضيه وأنصار التدخل، خاصة عندما قرر، بينما مجلس الأمن يناقش مشروع القرار، أن يرسل جنوده البواسل إلى بنغازي التي يسكنها قرابة مليون شخص، جلهم معارضون لحكمه. وكان يحذر، وهو يفعل ذلك، من أنه سيدمر المنازل فوق رؤوس أهلها، وأنه 'لن يرحم أحداً'. ويجيء هذا التحذير بعد أن رأى الناس مصداق قوله في المدن التي اجتاحها مثل الزاوية وأجدابيا، وتلك التي حاصرها، مثل مصراتة، حيث بالفعل لم يرحم جنوده البشر ولا الحجر. وهناك بالطبع دوافع أخرى، لأن آخر ما تريده أوروبا اجتياح مدن ليبيا الكبرى وخلق مشكلة لاجئين بهذا الحجم عند سواحل أوروبا الجنوبية. وقبل ذلك كان قيام ميلوسوفيتش باجتياح كوسوفو عام 1999 وإرسال عشرات الآلاف من اللاجئين غرباً إشارة الانطلاق لحلف الأطلسي للتدخل هناك بدون انتظار أي قرار أممي، لأن الأمر كان أشبه بهجوم مباشر على دول غرب أوروبا.
وستحدد نتائج هذا التدخل مستقبل المبدأ. فإذا كان التدخل ناجحاً وأدى إلى نتائج إيجابية، فيسشجع ذلك على تكراره في مواقف مماثلة. أما إذا أعاد إنتاج الحالة العراقية ومزالقها، فإنه سيكون علامة تحذير أخرى. ولكن من الصعب توقع حدوث تراجع كبير عن مبدأ التدخل، لسبب بسيط، وهو كاميرات التلفزة والانترنيت. فقد أمكن تجنب التدخل في رواندا عام 1994 ثم الكونغو بعد ذلك لأن مشاهد القتل الجماعي لم تعرض حية أمام الملايين. ولكن مشهد أكراد العراق في الجبال، أو ألبان كوسوفو وهم يجتاحون حدود أوروبا الغربية، ما كان يمكن تجنبه، وبالتالي ما كان يمكن السكوت عليه. والمرجح أن يكون التدخل في ليبيا ناجحاً، لأن الوضع هنا يختلف عن العراق وانقساماته. فالنظام قد انهار فعلاً، وكثير من أنصاره ينتظرون فرصة للقفز من السفينة كما فعل إخوان لهم من قبل أصبحوا اليوم من قيادات المقاومة. وقد وحدت الثورة الليبيين كما كان الحال في مصر وتونس، وكل الدلائل تشير إلى أن انهيار النظام الوشيك سيعقبه نظام منفتح ومستقر ومتصالح مع شعبه والعالم حوله. وسيسجل أنصار التدخل هذا باعتباره إنجازاً، كما أنه سيخلص كل من أمريكا وبريطانيا من عقدة العراق وسيمثل خبطة علاقات عامة ناجحة، حيث أن كل العرب ومعظم المسلمين هم اليوم من مشجعي فريق كاميرون-ساركوزي، وهو ما لم يكن أي منهما يحلم به.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
لا شك أن دينق كان يستحضر الحالة السودانية وهو يسطر ما كتب، إذا أن حرب الجنوب كانت في أوجها في تلك الأيام، وكان الكثيرون من منتقدي الحكومة السودانية، ودينق من بينهم، يرون أنها ارتكبت تجاوزات فاقت حد الاحتمال، واستوجبت التدخل الأجنبي. ولكن فكرة التدخل في شؤون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تكن مستساغة وقتها، لأن ميثاق المنظمة شدد على عدم التدخل ما لم يقع تهديد للسلم الدولي. بل إن المجتمع الدولي أدان مثل هذا التدخل، كما كان الحال عندما تدخلت فيتنام عام 1979 في كمبوديا لإطاحة نظام الخمير الحمر ذي السجل الأسود في مجال الإبادة الجماعية، فلم تحصد سوى الإدانة، حتى من الدول الغربية. وعليه كان لا بد من طرح جديد يبرر مثل هذا التدخل.
لم تكن الحالة السودانية هي الوحيدة التي شجعت هذا الطرح، حيث تفجرت أزمات متلاحقة منذ بداية التسعينات، خاصة في افريقيا، جعلت قضية المسؤولية الدولية الجماعية عن أمن المدنيين في مناطق النزاع مطروحة بقوة على بساط البحث. وكانت أزمات الصومال وليبريا من أبرزها، حيث انهارت الدولة في تينك البلدين، ولم يعد للحديث عن السيادة معنى في غياب الدولة ومؤسساتها، وانتشار حالة الفوضى وتجبر الميليشيات على المدنيين العزل. وقد أدى هذا إلى عدة مستويات من التدخل لمعالجة الطوارئ الإنسانية الناتجة. ففي ليبيريا تدخلت منظمة دول غرب افريقيا عام 1990 لإقرار السلم هناك، وفي الصومال تدخلت الأمم المتحدة في عام 1991 ثم الولايات المتحدة في عام 1992. في نفس تلك الفترة انعقد في عام 1991 مؤتمر كمبالا بمبادرة من الرئيس النيجيري السابق أولوشون أوباسانجو بغرض تطوير منظمة الوحدة الافريقية باتجاه تعميق مسؤوليتها التضامنية عن الأمن والسلم والتنمية والديمقراطية لكل شعوب القارة. وبحسب وثائق وتوصيات ذلك المؤتمر فإن هذا التوجه كان يتطلب التدخل لحفظ الأمن وفض النزاعات والتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
في نفس تلك الفترة وقعت حوادث جسام في بلدان مثل رواندا وسيراليون ويوغسلافيا السابقة أحدثت صدمة دولية نسبة لحجم الفظائع والمجازر التي ارتكبت، وأيضاً لعجز المجتمع الدولي والمؤسسات الإقليمية عن التصدي لتلك الفظائع أو التأخر في ذلك. وفي عام 2001 شكلت الحكومة الكندية لجنة دولية برئاسة وزير خارجية أستراليا الأسبق غاريث إيفانز نشرت تقريراً دعا إلى إقرار مبدأ ما سمي بـ 'مسؤولية الحماية'، مطوراً بذلك فكرة 'أمانة السيادة' التي طرحها دينق ورفاقه. وبحسب هذا المبدأ فإن هناك مسؤولية أممية جماعية لحماية الفئات التي تتعرض لخطر الإبادة أو الانتهاكات الجسيمة، وأن هذه المسؤولية يجب أن يتم الاضطلاع بها في مبتدأ الأمر بالوسائل الدبلوماسية والوقائية، ولكن إذا فشلت تلك الوسائل، فإن التدخل العسكري المباشر يصبح واجباً شريطة أن يجيزه مجلس الأمن، مع وضع الاحتياطات بعدم إساءة استخدام هذا المبدأ من دول قد تكون ذات مطامع استعمارية.
لم يلق التقرير ومناشداته أذناً صاغية بادئ الأمر، لأن أحداث الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر غطت على ما عداها، ولكن الأمم المتحدة عادت لمناقشة الأمر بعد حين، وتم تبني المبدأ رسمياً في قمة عقدت في نيويورك عام 2005 (شارك فيها السودان على مستوى الرئاسة). وفي تلك الفترة كانت قضية دارفور أصبحت محور اهتمام دولي غير مسبوق، وضغوط من جهات عدة رسمية وشعبية للتدخل باسم هذا المبدأ، خاصة بعد أن صنفت الولايات المتحدة ما وقع في دارفور على أنه إبادة جماعية. وكان الكثيرون يرون أن تبني مثل هذا المبدأ لم يقع إلا للتصدي لأزمات مثل دارفور، رأى الكثيرون أن الدولة قصرت فيها في حماية المدنيين، بل ساهمت في استهدافهم. إلا أن المبدأ لم يطبق في دارفور كما تصور له من صاغوه، وذلك لعدة أسباب، أولها هو أن الدول التي كانت تتصدى عادة لمثل هذا التدخل، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، كانت في ذلك الوقت غارقة حتى أذنيها في حروب أفغانستان والعراق، إضافة إلى أن مكانتها كدول صالحة للاضطلاع بدور إنساني أصبحت موضع تساؤل بعد تدخلها السافر في العراق لأسباب لم تكن الدوافع الإنسانية من بينها. من جهة أخرى فإن نفس تلك الدول كانت حريصة على علاقتها مع الخرطوم لأنها كانت كذلك منهمكة في مفاوضات نيفاشا التي كانت تخشى أن تفشل لو أصبح التدخل في دارفور واقعاً. هناك أيضاً دلائل على أن الجهات الدولية لم تكن مقتنعة تماماً بتأكيداتها حول وقوع الإبادة الجماعية، التي تحتم بالضرورة تحركاً سريعاً ومباشراً للتصدي للكارثة.
في نفس الوقت كان الاتحاد الافريقي، الذي طور مؤسساته وفق مبادئ مؤتمر كمبالا، جاهزاً للعب دور في التصدي للأزمة، وقد بادر لذلك بالفعل. ولهذا وجدت الدول المعنية في هذا الدور عذراً ومخرجاً، حيث خولت الاتحاد الافريقي الاضطلاع بمسؤولية واجب الحماية نيابة عن المجتمع الدولي. ورغم أن قرارات اتخذت فيما بعد بتكليف الأمم المتحدة هذا الدور، إلا أن الاتحاد الافريقي ظل هو 'الوكيل المعتمد' للمجتمع الدولي فيما يتعلق بمهمة الحماية في دارفور. وجدير بالذكر أن فرانسيس دينق، مستشار أمين عام الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية (كان يتولى حينها مهمة ممثل الأمين العام لشؤون النازحين) أيد في ذلك الوقت قرار عدم التدخل لصالح الدور الافريقي، قائلاً إن التدخل سيعقد الأمور وقد يطيح باتفاقية السلام الشامل.
ما شهدته دارفور يؤكد أن التوجه العام لدى المجتمع الدولي هو الحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بالتدخل الإنساني، لأن معظم الدول تتردد كثيراً خشية التورط في حروب أهلية لا نهاية لها، خاصة حينما لا تكون لها مصلحة مباشرة في الأمر، مما يجعلها تتلمس المعاذير لتفادي التدخل. وحتى بعد قرارات الأمم المتحدة، ما تزال الدول لم توف بتعهداتها تجاه القوة الأممية الافريقية المشتركة في دارفور. وهذا يشير إلى إشكالية أخرى تواجه إنفاذ مبدأ التدخل الإنساني: الكلفة. فالتدخل العسكري مكلف جداً، حيث ظلت الولايات المتحدة على سبيل المثال تنفق أربعة مليارات دولار شهرياً في العراق، وتواجه قوات الاطلسي في أفغانستان تكاليف مقاربة. وحتى في عملية محدودة مثل قوات اليوناميد في دارفور، فإن الكلفة تبلغ أكثر من مليار ونصف المليار دولار سنوياً. وعليه فإن الدول القادرة ستختار بعناية مواقع تدخلها، لأنها ببساطة لن تتمكن من التدخل في كل مكان يتعرض فيه الناس لوطأة حكامهم.
من هنا فإن الحالة الليبية تعتبر بحق أول حالة من حالات التدخل الإنساني المشرع دولياً منذ أن تبنت الجمعية العامة المبدأ في قمة عام 2005، وهو تدخل جاء بعد التردد المعهود والخلافات بين الفرقاء. وكان المستغرب موقف الجامعة العربية غير المسبوق بالانحياز إلى الشعب ضد نظام عضو في الجامعة، وهو ما كانت كل الأنظمة ترفضه وتخشاه. فبخلاف الاتحاد الافريقي الذي طور مؤسسات ومبادئ ملزمة للأعضاء ومبررة للتدخل في شؤون دوله، ظلت الجامعة العربية نادياً للأنظمة ضد الشعوب، لم تحرك في يوم ساكناً لنصرة مواطن. وقد رأينا مصداق ذلك في الموقف من انقلاب موريتانيا في عام 2008، حيث تصدى الاتحاد الافريقي للانقلابيين وجمد عضوية موريتانيا ومارس الضغوط على المجلس العسكري، بينما وقفت الجامعة متفرجة، بل مؤيدة على استحياء.
ويبدو أن السر في موقف الجامعة هو أن القذافي لم يترك صديقاً، بحيث كان لكل دولة عضو ثأر أو مشكلة معه. وليس صدفة أن الحكومة اللبنانية، التي يغلب عليها أنصار موسى الصدر المغيب في ليبيا، كانت ممن تبنى القرار الأممي. كذلك فإن القذافي ظل يمثل أفضل دعاية لمعارضيه وأنصار التدخل، خاصة عندما قرر، بينما مجلس الأمن يناقش مشروع القرار، أن يرسل جنوده البواسل إلى بنغازي التي يسكنها قرابة مليون شخص، جلهم معارضون لحكمه. وكان يحذر، وهو يفعل ذلك، من أنه سيدمر المنازل فوق رؤوس أهلها، وأنه 'لن يرحم أحداً'. ويجيء هذا التحذير بعد أن رأى الناس مصداق قوله في المدن التي اجتاحها مثل الزاوية وأجدابيا، وتلك التي حاصرها، مثل مصراتة، حيث بالفعل لم يرحم جنوده البشر ولا الحجر. وهناك بالطبع دوافع أخرى، لأن آخر ما تريده أوروبا اجتياح مدن ليبيا الكبرى وخلق مشكلة لاجئين بهذا الحجم عند سواحل أوروبا الجنوبية. وقبل ذلك كان قيام ميلوسوفيتش باجتياح كوسوفو عام 1999 وإرسال عشرات الآلاف من اللاجئين غرباً إشارة الانطلاق لحلف الأطلسي للتدخل هناك بدون انتظار أي قرار أممي، لأن الأمر كان أشبه بهجوم مباشر على دول غرب أوروبا.
وستحدد نتائج هذا التدخل مستقبل المبدأ. فإذا كان التدخل ناجحاً وأدى إلى نتائج إيجابية، فيسشجع ذلك على تكراره في مواقف مماثلة. أما إذا أعاد إنتاج الحالة العراقية ومزالقها، فإنه سيكون علامة تحذير أخرى. ولكن من الصعب توقع حدوث تراجع كبير عن مبدأ التدخل، لسبب بسيط، وهو كاميرات التلفزة والانترنيت. فقد أمكن تجنب التدخل في رواندا عام 1994 ثم الكونغو بعد ذلك لأن مشاهد القتل الجماعي لم تعرض حية أمام الملايين. ولكن مشهد أكراد العراق في الجبال، أو ألبان كوسوفو وهم يجتاحون حدود أوروبا الغربية، ما كان يمكن تجنبه، وبالتالي ما كان يمكن السكوت عليه. والمرجح أن يكون التدخل في ليبيا ناجحاً، لأن الوضع هنا يختلف عن العراق وانقساماته. فالنظام قد انهار فعلاً، وكثير من أنصاره ينتظرون فرصة للقفز من السفينة كما فعل إخوان لهم من قبل أصبحوا اليوم من قيادات المقاومة. وقد وحدت الثورة الليبيين كما كان الحال في مصر وتونس، وكل الدلائل تشير إلى أن انهيار النظام الوشيك سيعقبه نظام منفتح ومستقر ومتصالح مع شعبه والعالم حوله. وسيسجل أنصار التدخل هذا باعتباره إنجازاً، كما أنه سيخلص كل من أمريكا وبريطانيا من عقدة العراق وسيمثل خبطة علاقات عامة ناجحة، حيث أن كل العرب ومعظم المسلمين هم اليوم من مشجعي فريق كاميرون-ساركوزي، وهو ما لم يكن أي منهما يحلم به.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن





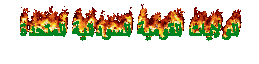






0 التعليقات:
إرسال تعليق